سيدة الصالون… أم كاهنة الفساد في عصر الانحطاط؟

سيدة الصالون… أم كاهنة الفساد في عصر الانحطاط؟
د. تمام كيلاني*
ليدي “جيلين”… سيدة القصر!
الابنة الصغرى لعملاق الصحافة
إنها الابنة الصغرى لإمبراطور الصحافة في بريطانيا، روبرت ماكسويل، الرجل الذي كانت الأبواب تُفتح له قبل أن يطرقها، وتُفرش له السجادات قبل أن تطأها قدماه، ثم اختفى ذات ليلة فوق يخته في عرض البحر، دون أن يعرف أحد كيف سقط، أو من أسقطه، أو لماذا أُغلق الصندوق الأسود على قصته إلى الأبد.
مات الأب…
وبقي الغموض.
وطُويت الملفات.
كما تُطوى عادة ملفات الكبار.
ومن تحت عباءة هذا الاسم الثقيل خرجت الابنة… لا كامتداد للمجد، بل كتحريفٍ له.
يُقال إن العفن لا ينبت فجأة، وإنما يتكوّن حين يُحجب الهواء، وحين تُغلق النوافذ،
وحين يعتاد المكان الظلمة حتى يظنها نورًا.
وكذلك البشر…
حين يحجبون عن أرواحهم شمس الضمير، تتراكم فوق قلوبهم طبقات من العطب، حتى يغدو الفساد فيهم طبيعة،
والخطيئة عادة، والانحراف أسلوب حياة.
في هذا العصر العجيب، أصبح العالم يفاخر بالتقدم، وأصبح العلم وسيلة لتزيين الجريمة، والثقافة مطية لتسويق الشهوة،
والأخلاق مزادًا علنيًا.
ورغم كل هذه الصيحات، تبين أن البشرية حين تغيب عن الله والدين، فلا معنى للإنسانية، ولا قيمة للمجد، ولا سلام للروح.
قال الله تعالى:
﴿ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى﴾
لم تكن بطلتنا فقيرة تبحث عن رغيف، ولا جاهلة تلهث خلف سراب.
كانت من طبقة تفتح لها الأبواب قبل أن تطرقها، ويُمهَّد لها الطريق قبل أن تطلبه.
وكان يمكن لها، لو شاءت، أن تكون رمزًا للفكر، أو صوتًا للعدالة،
أو نموذجًا لامرأة صنعت ذاتها بكرامة.
غير أنها اختارت طريقًا آخر…
طريقًا لا يحتاج إلى فكر، ولا إلى شجاعة، ولا إلى ضمير. اختارت أن تكون جسرًا…
تعبر فوقه الرذيلة إلى ضحاياها.
في ظاهرها:
سيدة مجتمع أنيقة، لبقة اللسان، ناعمة الحضور.
وفي باطنها:
سمسارة بشر، ومديرة تسويق للشهوة، ومقاولة من الباطن في مشروع الجريمة الكبرى.
وهنا يظهر اسم الرجل الذي صار مرادفًا للعار: إبستين.
رجل لم يصنع إمبراطوريته من الأفكار، بل من الابتزاز، ولا بنى نفوذه بالإنجاز،
بل بالأسرار.
وكانت هي بوابته الناعمة إلى الجحيم.
كانت تتحدث عن حقوق المرأة نهارًا، وتسحق المرأة ليلًا.
تبتسم للفتيات كما تبتسم الأم، ثم تسلمهن كما تسلم البضاعة.
يا له من عصر بديع!
يصنع من القبح وسامة، ومن الجريمة إنجازًا، ومن الخيانة “قصة حب معقدة”.
أما سيد القصر،
فكان نموذجًا للاستثمار الحديث:
استثمر في المال، واستثمر في النفوذ، واستثمر في صمت النخبة، واستثمر — قبل كل شيء — في تحطيم الأرواح.
وكانت هي الذراع الناعمة لهذا المشروع الخشن.
لم تكن تُجبر.
لم تكن تُكره.
كانت تختار.
وتخطط.
وتنفذ.
ومع ذلك…
كانت تحلم بالزواج.
نعم، بالزواج!
رأت أن الطريق إلى خاتم في الإصبع يمر عبر كسر آلاف القلوب.
رأت أن الحب يمكن بناؤه فوق مقبرة طفولة.
وقالت في تبجح لا يخلو من صفاقة:
“أبحث عن فتاة تُرضيه”.
لم تقل: تُنقذني منه.
لم تقل: تُبلّغ عنه.
لم تقل: أهرب.
بل تُرضيه.
كأنها تتحدث عن طفل مدلل، لا عن وحش بشري.
وهكذا تحولت المرأة الأرستقراطية
إلى موظفة استقبال في جحيم فاخر.
ثم ظهر فصل آخر من فصول التبرير:
الطبيبة الخاصة في الجزيرة
قررت أن تغسل يديها من الدم بماء الأعذار.
قالت إنها طبيبة معروفة في نيويورك، وإن عرضًا ماليًا هبط عليها لم تكن لتحلم به حتى في أكثر أحلامها جموحًا.
قالت إنهم أرسلوا لها طائرة خاصة، وإنها ذهبت وهي تظن أنها مجرد وظيفة محترمة في منتجع فاخر.
في البداية…
كانت “فقط طبيبة”. ثم بدأت ترى ما لم يكن ينبغي أن يُرى:
فتيات قاصرات.
جميلات.
عارضات أزياء.
وجوه بريئة تشبه الإعلانات…
وأرواح مكسورة تشبه المقابر.
فتيات يُدفعن، ويُضغط عليهن، ويُغرين، حتى يبعن أنفسهن باسم الحاجة، وباسم الخوف، وباسم الوعود الكاذبة.
والطبيبة؟
رأت.
وفهمت.
وسكتت.
ثم قالت لاحقًا:
“لم أكن أعرف”.
وكأن الجهل شهادة براءة، وكأن الصمت مهنة طبية.
هكذا يصبح الطبيب شاهد زور، وتصبح السماعة الطبية أداة للاستماع إلى أنين الضحايا
دون أي نية للعلاج.
ثم جاء المشهد الأعظم:
جزيرة في عرض البحر.
تُقدَّم للعالم على أنها فردوس للأثرياء، وتتبيّن حقيقتها لاحقًا كسوق نخاسة معاصر.
والصدمة ليست في وجود الجريمة، فالجريمة قديمة قدم الإنسان، بل في هوية الزبائن:
رؤساء دول.
أمراء.
حكام.
شخصيات يُقال إنها تمسك بمفاتيح العالم.
ونساء عربيات ومسلمات أيضًا.
نساء يفترض أن يحملن اسمًا ودينًا وتاريخًا.
لكنهن حملن حقائب السفر…
وتركن القيم في المطارات.
رجال ونساء يخطبون عن الشرف صباحًا، ويشترون العار مساءً. رجال يتحدثون عن حماية الأوطان، ولا يملكون القدرة على حماية أنفسهم من شهواتهم.
دنسوا المقدس، واستباحوا الطاهر، وتعاملوا مع القيم كما لو كانت ديكورًا قديمًا.
ثم عادوا إلى بلدانهم،
فارتدوا الأقنعة من جديد:
قناع الحاكم الورع، وقناع الزعيم الحكيم، وقناع الرجل الوقور.
يا لها من مسرحية متقنة الإخراج!
المجرم فيها خطيب.
والخطيب فيها قديس.
والضحية متهمة.
أما بطلتنا، فجلست في قفص الاتهام وما زالت ترى نفسها عاشقة مظلومة.
تحب من دمّرها، وتخدم من أهانها، وتتاجر لأجل من لن يعترف بها أبدًا.
وهنا تتجلى المأساة الكبرى:
أن يقتنع الإنسان
أن قيوده أساور.
ليست هذه حكاية امرأة فقط، ولا حكاية رجل فقط، ولا حكاية جزيرة فقط.
إنها حكاية عصر
استبدل الضمير بالمصلحة، والقيم بالعلاقات، والعدالة بالصفقات.
عصر يتعطر كثيرًا… كي لا تُشم رائحته الحقيقية.
ليست المأساة في أن يسقط بعض البشر…
فالسقوط جزء من الطبيعة البشرية.
المأساة الحقيقية
أن يتحول السقوط إلى نمط حياة، وأن يصبح الفساد “أسلوبًا”، والانحراف “ثقافة”، والجريمة “وجهة نظر”.
المأساة أن نعيش في عالم
يُحاسَب فيه الفقير على كسرة خبز، ويُبرَّأ فيه الأثرياء من اغتصاب الطفولة.
عالم تُكسر فيه يد السارق الصغير، وتُصافَح فيه يد السارق الكبير.
عالم يُصلَب فيه الضعفاء على أعمدة القوانين، ويجلس الأقوياء فوق تلك الأعمدة يلتقطون الصور.
ولكن الإنسان بلا ربّ… بلا دين… بلا ضمير…
يشبه السفينة بلا بوصلة، يضل الطريق، ويغرق في بحر الرذيلة.
قال رسول الله ( ص)
“الناس في ظل غياب الخوف من الله، كالقطيع يضلّ ولا يرعى”
ورغم كل هذا السواد، ورغم كل هذا التواطؤ، ورغم كل هذا الصمت المتآمر، فإن الحقيقة تشبه الماء:
قد تُحاصر، قد تُؤجَّل، لكنها لا تموت.
تشق طريقها من أضيق الشقوق.
وتخرج، حتى لو بعد حين.
والأهم…
أن القصور مهما ارتفعت، فهي مبنية على أرض.
والأرض في النهاية
تفتح فمها.
وأن الذين يبيعون أجساد الآخرين
لن يستطيعوا يومًا شراء راحة ضمائرهم.
وأن الذين دنسوا المقدسات
سيكتشفون متأخرين
أن المقدس لا يحتاج لمن يحميه…
بل يحتاج لمن يحمي نفسه منه.
أما الضحايا…
فقد خسروا براءتهم، لكنهم لم يخسروا إنسانيتهم.
وأما الجناة…
فقد ربحوا العالم، وخسروا أنفسهم.
وما بين الربح والخسارة، هناك ميزان لا يراه كثيرون، لكنه لا يخطئ أبدًا.
اسمه:
ميزان التاريخ.
وحين يميل…
لا يُعاد ضبطه.
وتلك…
هي العدالة التي لا تُشترى.
*رئيس اتحاد الاطباء والصيادلة العرب في النمسا
برفقة ترامب وابستين

مع ابستين
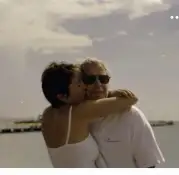
مع حبيبيها ابستين










