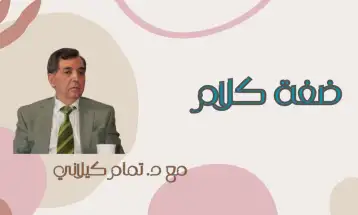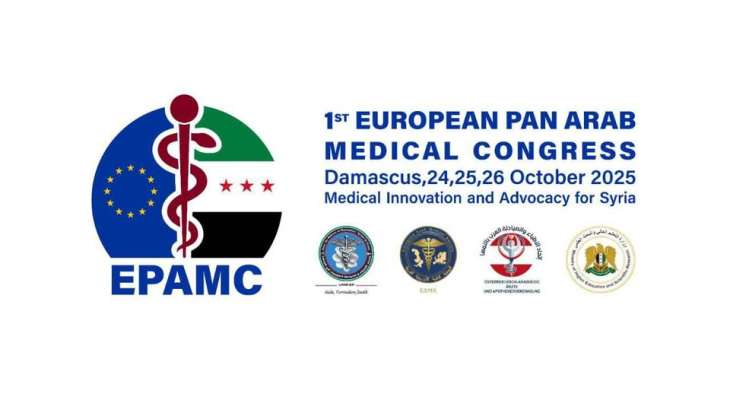الأحزاب القومية بين الشعارات والممارسات: قراءة تحليلية

د. تمام كيلاني، رئيس اتحاد الاطباء والصيادلة العرب بالنمسا
الأحزاب القومية بين الشعارات والممارسات: قراءة تحليلية
د. تمام كيلاني*
منذ بدايات القرن العشرين، مثلت الحركات القومية في العالم أحد أهم الفاعلين السياسيين الذين صاغوا التاريخ المعاصر. ظهرت هذه الحركات غالباً في ظروف استثنائية: هزائم عسكرية، أزمات اقتصادية، أو شعور جماعي بالإهانة والاستعمار. وقد رفعت شعارات التحرر والوحدة والنهضة، واكتسبت زخماً جماهيرياً هائلاً. غير أن التجربة العملية لهذه الحركات سرعان ما كشفت تناقضاً عميقاً بين ما رفعته من شعارات وما انتهت إليه من ممارسات، حيث تحول المواطن إلى الضحية الأولى لمشروع يفترض أنه بُني من أجله.
أولاً: التجربة الأوروبية – من الفاشية إلى الشيوعية
في أوروبا ما بين الحربين العالميتين، برزت النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا بوصفهما مشاريع قومية تسعى لإحياء “المجد القومي”. غير أن هذه المشاريع اعتمدت على عسكرة المجتمع وإلغاء الحريات، حتى تحولت الدولة إلى أداة حرب وقمع. وكانت النتيجة حرباً عالمية مدمرة خلّفت ملايين الضحايا.
وبالمقابل، انتهت الثورة البلشفية في روسيا إلى نموذج مشابه، رغم اختلاف مرجعيتها الفكرية. فقد حكم الحزب الواحد باسم “الطبقة العاملة”، لكنه مارس قمعاً واسعاً وفرض هيمنة شاملة على المجتمع والاقتصاد. وهكذا تكررت المعادلة ذاتها: زعيم مطلق، حزب مسيطر، ومواطن مغيّب تحت شعارات كبرى.
ثانياً: القومية في العالم العربي
مع منتصف القرن العشرين، انتقلت العدوى إلى الشرق الأوسط. فقد تبنى جمال عبد الناصر في مصر خطاب القومية العربية، بينما طرح حزب البعث في العراق وسوريا مشروعاً وحدوياً مماثلاً، وسبقهم كمال أتاتورك في تركيا بنموذج قومي صارم. رفعت هذه الحركات شعار التحرر من الاستعمار وبناء الدولة الحديثة، لكنها سرعان ما انزلقت إلى أنظمة أمنية مغلقة.
في هذه التجارب، أصبح المواطن مجرد وسيلة لخدمة السلطة: يُجَوَّع لتظل الدولة قادرة على التحكم به، ويُخَوَّف كي يبقى خانعاً، ويُقصى كي لا يتحول إلى مصدر تهديد. فبدلاً من النهضة الموعودة، أنتجت هذه الأنظمة صيغاً مختلفة من الاستبداد.
ثالثاً: القواسم المشتركة
رغم تباين الخطابات والشعارات، إلا أن أنظمة القومية – سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط – اتفقت على سمات أساسية:
- المركزية المطلقة للزعيم الذي يتحول إلى رمز شبه مقدس.
- احتكار السياسة عبر الحزب الواحد أو المسيطر.
- التوظيف الأمني للدولة باعتبار القمع الوسيلة الأساسية للحكم.
- السيطرة الاقتصادية باستخدام الموارد وسيلة لإخضاع المجتمع.
- إنتاج الخوف بوصفه أداة لإدارة العلاقة بين السلطة والمواطن.
رابعاً: المواطن بين الشعارات والواقع
بينما بشّرت هذه الحركات شعوبها بالكرامة والحرية، كانت النتيجة على الأرض مختلفة تماماً. المواطن وجد نفسه بين مطرقة الخوف وسندان الحاجة، محروماً من أبسط حقوقه، بينما يُطلب منه في الوقت نفسه التضحية باسم الأمة والوطن. هذه المفارقة تمثل جوهر المأساة القومية: خطاب تحرري في المظهر، وممارسة استبدادية في الجوهر.
خامساً: استمرارية النمط في القرن الحادي والعشرين
مع نهاية الحرب الباردة، توقع كثيرون أن هذا النموذج قد انتهى. لكن العقود الأخيرة أثبتت العكس، إذ عادت النزعة القومية لتظهر في صور متعددة:
روسيا في عهد بوتين: حيث جرى توظيف القومية لإعادة إنتاج سلطة مركزية قوية، قائمة على تقييد الحريات وتوظيف التخويف السياسي.
الشرق الأوسط بعد الربيع العربي: حيث استعادت أنظمة عدة خطاب “الوطن المهدد” لتبرير تشديد القبضة الأمنية.
الهند وصعود القومية الهندوسية: التي عززت التوترات الداخلية وأضعفت التعددية السياسية والمجتمعية.
سادساً: التجارب العربية ونتائجها الكارثية
إذا كان الخطاب القومي في العالم العربي قد بدأ بوعد التحرر والنهضة، فإن المحصلة النهائية في كثير من الدول كانت عكس ذلك تماماً:
-مصر: رسّخ نظام جمال عبد الناصر سلطة الدولة الأمنية، وأخضع المجتمع لحزب واحد ورؤية واحدة، ما أدى إلى تراجع التعددية السياسية وتقييد الحريات الفردية. وعلى الرغم من تحقيق بعض الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية في البداية، إلا أن النتيجة على المدى الطويل كانت دولة مركزية خانقة لم تسمح للمواطن بالمشاركة الفعلية في تقرير مصيره.
-سوريا: تحولت سلطة حزب البعث في ظل حافظ الأسد إلى نظام يقوم على الخوف المطلق. قُمع أي تعبير معارض بوحشية، وتحولت البلاد إلى دولة أمنية بامتياز. ومع مرور الزمن، تراكم القمع والتهميش حتى قادت البلاد لاحقاً إلى انفجارات اجتماعية وسياسية انتهت بكارثة إنسانية كبرى.
-العراق: حكم صدام حسين بالحديد والنار، فدُمرت الحريات السياسية، وجرى تسخير موارد الدولة لخدمة الحروب والمشاريع السلطوية. والنتيجة كانت عقوداً من الحروب الداخلية والخارجية، وعزلة سياسية، وانهيار مؤسسات الدولة بعد سقوط النظام.
هذه التجارب مجتمعة أدت إلى:
- دمار اقتصادي واجتماعي حال دون بناء دول مستقرة وقادرة على التطور.
- سحق كرامة المواطن العربي الذي عاش عقوداً بين الخوف والجوع والتهميش.
- إضعاف المؤسسات الوطنية، بحيث ارتبطت الدولة بالزعيم والحزب أكثر من ارتباطها بالمجتمع.
- غياب الحريات العامة، إذ تحولت الحرية إلى ترفٍ مستحيل في ظل أنظمة تعتبر المعارضة خيانة، والمطالبة بالحقوق تهديداً للأمن القومي.
سابعاً: تجربة إيران بعد الثورة الإسلامية
تعتبر تجربة إيران بعد ثورة الخميني عام 1979 حالة متميزة، حيث قامت الثورة على أسس دينية وفكرية تهدف إلى إقامة دولة إسلامية تحكم وفق الشريعة. ورغم اختلاف المرجعية الدينية عن الحركات القومية الأوروبية أو العربية، إلا أن نمط السيطرة على الدولة والمواطن يعكس عناصر مشتركة مع هذه التجارب:
- المركزية المطلقة للزعيم: تولى المرشد الأعلى دور السلطة العليا، وبات رمزا مقدسا للسلطة والسياسة في البلاد.
- احتكار السلطة عبر مؤسسات الدولة: سيطر النظام على كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية، وتحول البرلمان والحكومة إلى أدوات تنفيذية، وليس منصات حقيقية للتمثيل الشعبي.
- القمع والأمن كأداة للحكم: جرى استخدام الأجهزة الأمنية لتأمين الولاء السياسي، وقمع المعارضين داخلياً وخارجياً.
- التوسع الإقليمي عبر الميلشيات والفصائل المسلحة: توسعت إيران خارجياً عبر دعم ميلشيات وفصائل مسلحة في لبنان (حزب الله)، والعراق، وسوريا، واليمن، لتحقيق نفوذ وسيطرة إقليمية، وهو ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين والعسكريين وتفاقم الصراعات الداخلية.
بهذه الصورة، تكشف تجربة إيران أن الحركات التي تبدأ بأهداف “تحررية” أو دينية يمكن أن تتجه إلى نسق سلطوي وإقليمي مماثل لما شهدته التجارب القومية الأخرى: تعزيز السلطة المركزية، القمع الداخلي، والتوسع الخارجي باسم المشروع القومي أو الديني، مع تحميل المواطن العادي ثمن الصراعات والسيطرة.
خاتمة
تكشف التجارب التاريخية والمعاصرة للأحزاب والحركات القومية والسلطوية عن نمط متكرر: الشعارات التي رُفعت باسم النهضة والوحدة أو الدين تحولت إلى أدوات استبداد وقمع. المواطن الذي وُعد بالتحرر أو العدالة أصبح الحلقة الأضعف في معادلة السلطة. لذلك، يمكن القول إن القومية أو السلطة الدينية، متى ارتبطت بالزعيم المطلق والحزب أو المؤسسة المسيطرة، تتحول من مشروع لبناء الأمة أو المجتمع إلى أداة لتدميرها من الداخل، داخلياً وخارجياً، مع إلحاق خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية هائلة.
*رئيس اتحاد الاطباء والصيادلة العرب بالنمسا/ فيينا.
كلمات البحث
إقرأ أيضًا
فن التصفيق المستدام: مهارات الحفاظ على راحة اليد دون التوقف عن التصفيق لساعات
الثورة السورية.. انتصار الإنسان لا مكاسب الأشخاص
أزمة الدولة الوطنية في سورية بين الأكثريات والأقليات
“لينفق ذو سعة من سعته”.. مشروع حياة لإعادة إعمار سورية
التعليم أولوية سورية الجديدة… لا نهضة بلا تحرير العقول
الاكثر شهرة
أسئلة مباحة في زمن صعب!!
أسئلة مباحة في زمن صعب!! رامة ياسر حسين* هل حصلنا على الحرّيّة حقًّا أم زادت المسافات...
المؤتمر الطبي الأوربي العربي الأول بدمشق
المؤتمر الطبي الأوربي العربي الأول بدمشق مؤتمر الياسمين فن ومدن* تحت عنوان (الابتكارات الطب...
عندما يغلق المراهق بابه كيف نفتح باب الحوار
عندما يغلق المراهق بابه كيف نفتح باب الحوار ملاك صالح صالح* في الكثير من البيوت العربية،...
الطفولة المعنّفة.. كيف تنجو من ذاكرة الجسد!!
الطفولة المعنّفة.. كيف تنجو من ذاكرة الجسد!! ملاك صالح صالح* قبل أن تبدأ رحلتنا في بحر ال...